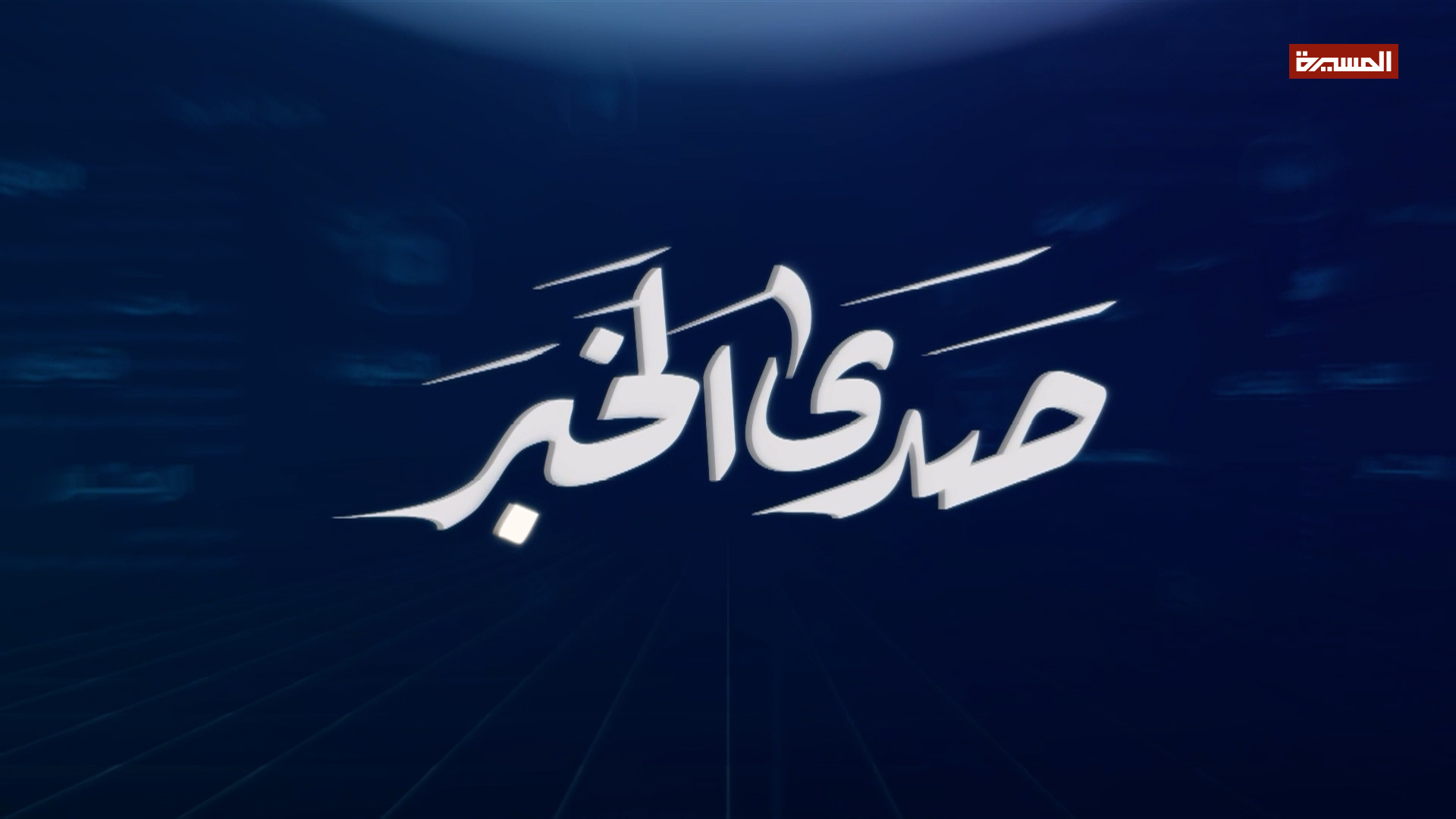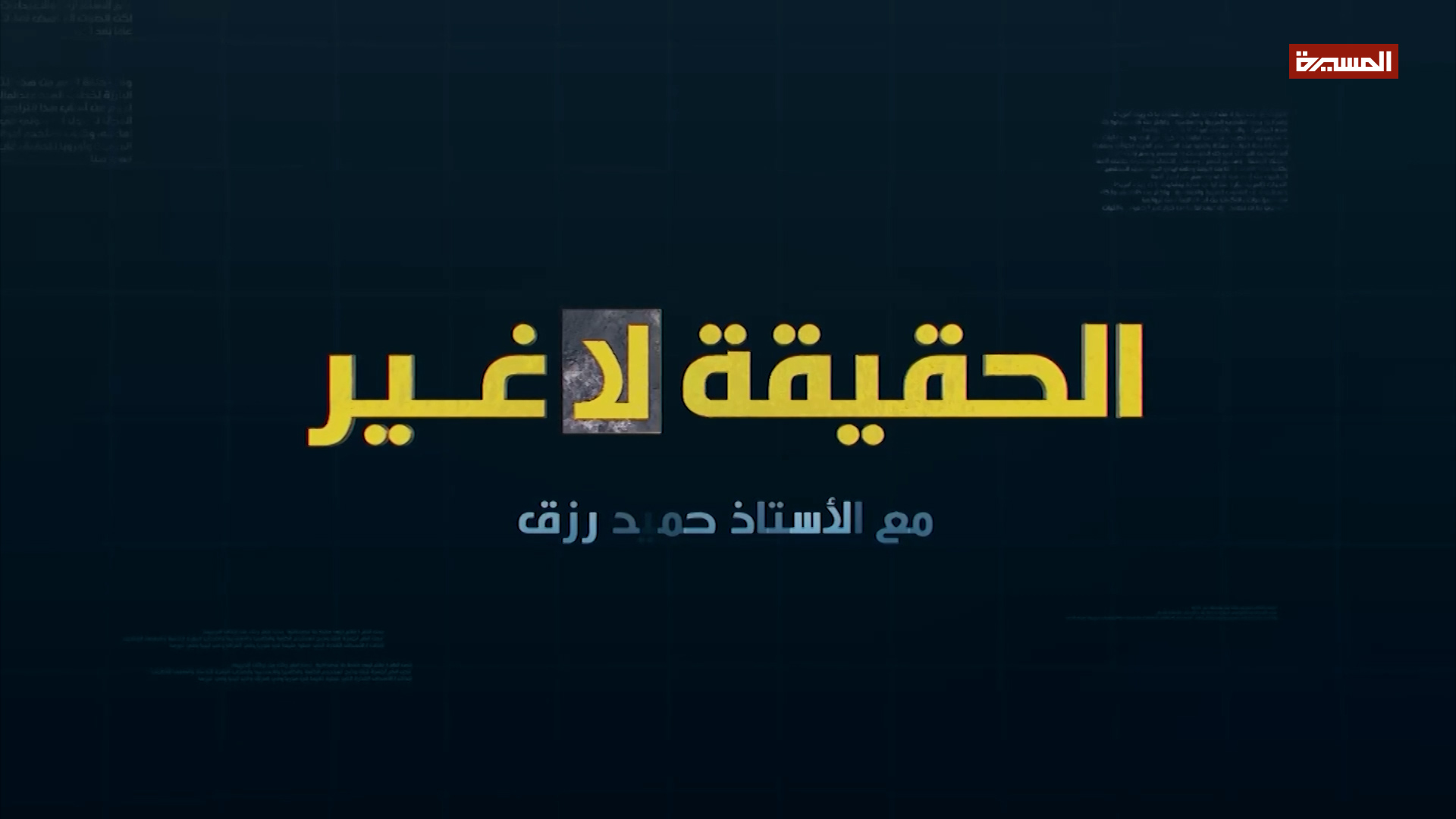-
العنوان:لا توبةَ بلا اتِّباعٍ لأحسن ما أُنزِل
-
المدة:00:00:00
-
الوصف:قراءةٌ في درس: الدرس الحادي عشر {قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوْا عَلَى أنفسهِمْ}.
-
التصنيفات:مقالات
-
كلمات مفتاحية:
من يطالع هذا الدرس لشهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه يرى أن خطابَ الرحمة الإلهية لا يتعارضُ مع جدّية التكليف، بل يفتح بابًا واسعًا للعودة ثم يُلزم الداخلين أن يسيروا في الطريق كله لا في بعضه.
يبتدئُ
النص بنداءٍ رقيقٍ للمسرفين: قال شهيد القرآن: (قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ
أَسْرَفُوا عَلَى أنفسهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جميعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيم)، لكنه يعقب النداء
بتشخيصٍ علاجي: «وَأَنِيبُوا..
وَأَسْلِمُوا..
وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ».
هنا
تتبدّد أوهامُ «التوبةِ الشعورية» المنزوعةِ العمل؛ فالتوبةُ، كما يعرضها النص، نقطةُ
انطلاق لمنهجٍ عمليٍّ متكامل.
يُصِرُّ
الدرسُ على مبدأ التكامل، فشعائرُ العبادات خادمةٌ للمقاصد الكبرى، قال شهيد القرآن
عن الصلاة والزكاة وسائر الشعائر إنها «كلها في خدمة المبادئ المهمة.. وأعلاها
الجهاد في سبيله».
قال
الله تعالى: (أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ
الْيَتِيمَ، وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ)، وحين يُهمل المجتمع
«المبادئ الكبيرة» ينكمش الدين إلى طقوسٍ لا تُنتج أثرًا، وتتحول العبادة إلى إسقاط
واجبٍ يُجنِّبك فقط مؤاخذةَ الترك، من غير ثمرةٍ في الواقع.
ويحذّر
النص من الذنوب «غير المرئيّة» التي تآلفنا معها حتى «لا نشعر» بها؛ ذنوبُ التفريط
الجماعي، وفصْلُ الدين عن واجباته الاجتماعية والجهادية.
هنا
يتجلّى بُعدٌ تربويٌّ دقيق: الخطرُ ليس في المعصية المعلومة فقط، بل في حالة
التواطؤ الصامت التي «يغُشّ بعضُنا بعضًا» وتمنع اللسان من تذكير أخيه بالتقصير.
لذلك
يجيء الإنذار السماوي: «مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً»؛ لأن
من يمشي بعينٍ مغمَضةٍ قد لا يفتحها إلا على شفير جهنم.
ومن
علامات الصدق أن يتبدّل معيار السؤال عند المؤمن: بدل عبار: «هل قد وجب؟» يصبح
الميزان مبدأ: «هل في هذا لله رضا؟»؛ فهذا السؤال يوسّع دائرة الخير، ويكسر ذهنية
"المقاصاة".
قال
شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه: «جهنم ليست مما تُقاصى..
ليكن
سؤالك: هل هذا العمل فيه وقاية من النار؟ هل فيه لله رضا؟».
بهذا
الميزان تغدو الأولويات واضحة، ويتحوّل الإنفاق والجهاد والنصيحة ووحدة الكلمة من
«هوامش» إلى صُلب التقوى.
كما
يفضح الدرسُ «التكذيبَ العملي» وإن تستّر بعبارات الإيمان.
قد
تُعلن لسانًا: نؤمن بجهنم، لكنك تقف من آيات الجهاد والإنفاق موقفَ الرافض
المتأوِّل؛ فيسمي النصّ هذا تكذيبًا واستكبارًا.
قال
شهيد القرآن: «الإيمان كله عملي..
أما
مُجَـرّد إيمان لا يتبعه عمل فتُعتَبَر كمن ليس بمؤمن»، ولذلك تُسودّ وجوه «مَن
كذبوا على الله» حين يُوظَّف الكلامُ باسم الدين لحراسة السكون والقعود.
ولأجل
ذلك يعيدُ النصُّ تعريفَ النجاة، حين يؤكّـدُ أنها ليست لقبَ «مؤمن» ولا رصيدَ
شعائر، بل صفة عملية لـ «المتقين المحسنين».
قال
شهيد القرآن مستشهدًا: «أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ
وَالضَّرَّاءِ، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ»، ثم يختم بالبشارة: «وَيُنَجِّي
اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، لا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلا هُمْ
يَحْزَنُونَ».
إنها معادلة واضحة: توبةٌ صادقة، فاتباعٌ لأحسن ما أُنزل، فعملٌ يَنْفُذُ إلى قضايا الأُمَّــة، فيثمر فلاحًا لا حزن معه.

🔵 تغطية إخبارية | عن مليونية (نفير واستنفار.. نصرة للقرآن وفلسطين) بـ #ميدان_السبعين في #صنعاء | 29-06-1447هـ 19-12-2025م

تغطية ميدانية | مليونية (نفير واستنفار.. نصرة للقرآن وفلسطين) بـ #ميدان_السبعين في #صنعاء | 29-06-1447هـ 19-12-2025م

تغطية إخبارية | حول التحرك الشعبي والرسمي في اليمن نصرة للقرآن الكريم | مع د. حمود الأهنومي و فهمي اليوسفي و د. محمد الشيخ 28-06-1447هـ 18-12-2025م

تغطية إخبارية | حول التحرك الشعبي والرسمي في اليمن نصرة للقرآن الكريم | مع د. جهاد سعد و عبدالإله حجر و الشيخ الدكتور عامر البياتي 28-06-1447هـ 18-12-2025م